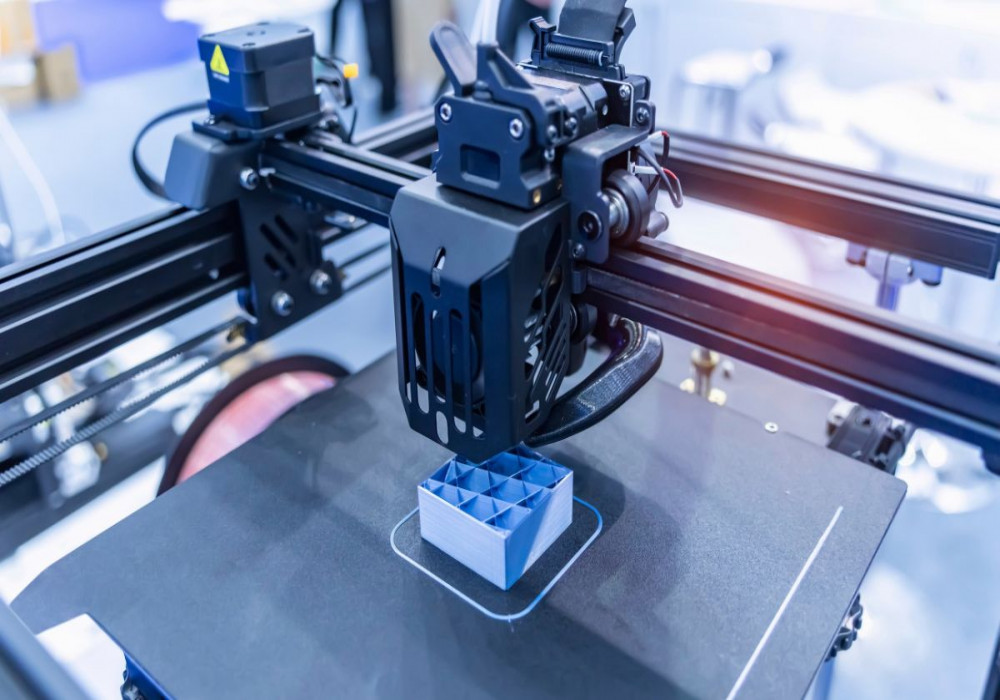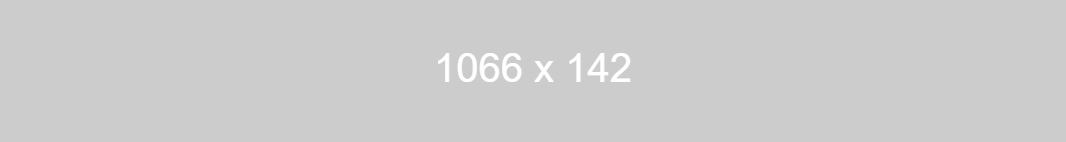الأخبار المحلية
الأخبار الدولية
السياسة
الاقتصاد والأعمال
رياضة
الثقافة والفنون
العلوم والتكنولوجيا
RSS NEWS
VIDEO